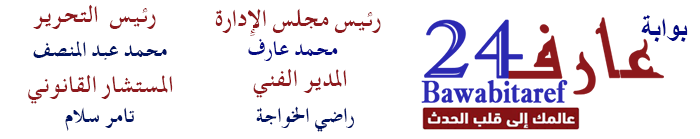مقالات
الأستاذ محمد حسنين هيكل فى ذكراه .. إلا الذكرى هى التى تبقى ..
الدكتور محسن عبد الخالق
الأستاذ محمد حسنين هيكل فى ذكراه ..إلا الذكرى هى التى تبقى ..
تأخَّرت فى الكتابة لأسباب تتعلق بصحَّة " إبنتى " تلك التى غيرت لغة النبض ، غيرت خطواتى ..
والحمد لله ..
فقد إعتَدّتُ دائِمًا أن تكون كريمًا معى وتُقَدّر ..
حَقًا ..
ليس أدعى إلى الأسى من يوم تفقد فيه أستاذا صَديقًا تُحِبه ..
فى مثل هذا اليوم منذ أربعة سنوات غاب عن الدنيا أستاذى وصديقى الأستاذ " محمد حسنين هيكل " ، رجل تجاوز جميع الألقاب التى تسبق الأسماء عادة ، هو فى سِجِلات التاريخ والمعرفة الرصينة أحد أعظم أساتذة الصحافة الكونية ، أو كما كان يقول الأوائلُ :
" فى كل ألف سنة رجل لا نظير له " عبارة أستحضرها فى ذهنى تكريمًا ، وتلمع برقُا فى خواطرى إعلاءًا لمن كان وجوده فى الحياة نَصر للحياة . بعد كل لقاء أعود إلى بيتى إنسان غير الذى عَرِفته ..
أتذكّر لحظة الفراق حين كان القمر حَزِينًا شَاحِبًا يشكو ظلمة الليل إلى النُّجوم من حوله ، فيما كانت النُجومّ ساهرةُ تحرس صَمت الفضاء الذى أخذ يبعث لنا بنداء الحقيقة نسمعه يتردد رجع صدى فى الأفق ..
أعرف أنه لا يوجد إنسان لم يحزن فى حياته ، لكن من منكم رأى الحزن وهو يُمطِر ..
كان أعظم ما أحبه وأحترمه فى هذا الأستاذ أنه لم ينس نفسه برغم ما تفتح أمامه من ألأبواب ، وأنه كان يُمَثّل بمفرده عصرًا رأيته رؤى العين ولم أقرأ عنه فقط ، أى أننى استعيد الناس والأماكن وليست الصفحات والكلمات فقط . كنت أزهو أنى موجودُ إلى جوار " لَمعَة نِجم " فى مَجَرَّة فضَائية يَصعُب رَصد حجمها ، ويَصعب حصر تأثيرها ، وأنى كنت مَحظُوظًا أنى أحيَا عصره وأن العصر عصره ، تكرَّمت المقادير وكنت تلميذًا مُقَرَّبًا منه ، ربما تلمس عُمق صِلة بين تلميذ وأستاذ أكبرهما يرى " الوَعد " فى الأصغَرِ ، والأصغر يرى " المثل " فى الأكبر ، وكثيرًا ما كنت بِصُحبَته وهو يسير بِمُحَاذَة السَحاب مُحَلِقًا بأجنحة جاوزت به الأفق المَرئِى وبعده أيضًا ، كنت أسمع وأرى مأخوذًا بِدِهشة الإعجاب برجل إختارأن يكون نفسه وأستاذًا كان له أكبر الأثر فى حياتى باحِثًا قَلما تتاح له المراقبة عن كَثَب ، ودَارِسًا ، ومُحَققًا ، ومُدقِقًا ..
كنت أقرأ المقالات كأنى أكتبها تماما ، وهى مازالت تحتفظ بعلامات قلمى الرصاص تحليلا لعناصرها ، حتى ليُخَيَّل إلىَّ أنى أكتبها ، وأن يدى تعزِفُ إلى جوار يَدِه على نفس الأوتار ، مع أن الكتابة عَزفُ مُنفَرد على أوتار اللغة . كانت كتاباته تبعث برسائل وإشارات ضوئية مُوجزَة إلى أقدَم المَمَرَات للخروج من قتام الليل إلى شروق النهار ..
كان الأستاذ " هيكل " لى ولجيلى جامعة كبرى تعلم فيها كُثُرُ من رجال السياسة والفكر والصحافة دَرسهم الأهم فى عِلم الصراع ..
كان أول درس تعلمته أن أكبر قدر من النجاح يرتبط بأقل قدر من الكلام ، وكلما تكلمنا أكثر كشفنا من مواقعنا واقعة أوسع ، وكلما كشفنا المزيد من مواقعنا ضاقت أمامنا مساحة الحركة وحرية التصرف ، وأن ما أُسَجّله وأدوّنه فى مُفَكِرتى وأوراقى أن يكون وراء كل كلمة سَنَد ، وكل حِكايَة وثِيقَة ، وكل خَبر مَصدرًا .. تعلمت أن القراءة عمل من أعمال " العبادة " ، وأن الكتابة عمل من أعمال " السيادة " وهى تدريب على الإبداع ، وأن سِعة الصَّدر عند بعض الناس مَوهِبة ، وأن الكبار لا تنزلق أقلامهم فى مستنقع الضغائن ، تَعَلَّمت فلسفة " النسيان العَادِل " ، وأن عليك أن تتأكد من جناحىَّ قبل الطير ، ولا تتحدث عن الفضاء والأجنحة مقصوصة ، وأن القلق عنصرا خلاقا ويبعث على التفكير والخروج من المأذق ، وأن الحوار هو مُحرك الثقافة ومدار الحضارة ، وليس كل جديد صحيحًا ، وليس كل صحيح جديدًا ، وكان أكثر ما تعلمت هو أن أكون " نفسِى " .
عرفت الأستاذ " هيكل " طائِرًا مُحَلقًا يتجاهل كل الحُدُود ، صَوته فى أجنحته ، الحُريَّة عنده ليست حُرَّةُ ، فهى مُقَيَّدة بأفق الشَّخص الذى يُمَارسها ، وأن كل مُثَقَّف مُكَلَّف بتوسيع دائرة الحرية وعليه أن يختار ميادينه وحركته عليها بدِقَّة ، لأن أى تراجُعِ يفرض عليه معناه أن خطوط الحدود " ضَاقَت " وأن بعض المكاسب على الأرض " ضَاعَت " . عَرفته شعاعًا قادرًا هو على النفاذ إلى جوهر السَّوَاد ، عَرفت الشموخ ، والترفّع الإنسانى البديع ، وتلك الكبرياء العالية ، وعرفت المُفَكّر الذى خُلق ليقرأ ويكتب ويضِىء ، وكلها قِيَمًا عَالية ظلت دومًا فى حافظته المهنية ..
إختَلِف معه فى الرأى والرؤى كيفما شئت ، وأعترف أن هناك مناطق اختلاف بينى وبينه حول بعض القضايا ، بل وكانت بعض مناطق الإختلاف تتسع وقد لا تضيق ، ذلك أنى لا أقنع إلا بما هو مُقنِغ ، ومازلت إحتفظت بثبات موقفى عند نقطة الإعتقاد لا أتزحزح عنها حتى الآن ، لكنك لا تملك إلا أن تقف مأخوذا أمام الصفاء العقلى ، والرواء الفنى ، والشموخ الهندسى فى مقالاته ، وجلال اللغة ، وأسلوبه الساحر .. ولمن يريد أن يدقق ، فإن الأستاذ هيكل إستطاع أن يحقق فى كتاباته نوعًا من الإبتكار ، ذلك حين قام بعقد قَرانًا لُغَوِيًا بين المصطلح السياسى والتعبير الأدبى ، زيجة أدبية وفنية لم تعرفها الصحافة المصرية والعربية ، ولم تظهر إلا مع مقاله الأشهر " بصراحة " الذى ينهض على التحليل العنقودى للوقائع والأحداث ..
إختار الأستاذ " محمد حسنين هيكل " الصحافة بوصفها عِشقًا ، وظلّت دَومًا هى غَرامه وهواه ، وصارت هى كل ما يراه ، إختارها بوصفها فى لحظة فارقة المعنى على طريق تشعبت مسالكة ، وتقاطعت خطوطه ، وزادت منحنياته ومهاويه لتكون هى حياته التى يعيش فيها ، ورسالته التى بُعِثَ من أجلها ، وهى التى أعطاها عُمره ، وهى التى جَرى فى دِمائه عِطرُها ، وهى التى أخلص لها ، وظل وفِيًّا لطقوسها وأعرافها من لحظة الخلق وحتى صمت القبور ، فكان هذا الصعود المدهش على سُلّم المَعنى درجة بعد درجه ، وطابق يرتفع فوق طابق تحته ، بِصَبرِ فاهم وجلد ، حتى وصل الدرجة الأخيرة فى سُلم الضوء . وعلى طول المسافة الممتدة التى قضاها ناسِكا فى مِحراب الصحافة بوصفها " تاريخ تحت الطبع " ظل مُحَاطا بوهجِ خاطف أخَّاذ لا ينطفىء أبدًا ، وهوأينما ذهب أخذ معه هذا الوَهج على نحو باهرِ ومُدهِش ..
أذكر مرّة كان الأستاذ يُملى علىّ موضوعًا مهمًا ، وكان يقرأ الكلمات بسرعة ، وكنت أكتب وراءه العبارات بدون " شَولات " كى ألاحقه فإذا هو يقول لى :
أنت تكتب بدون سَكَتَات أى " شَولات " الكلمات تلهث إعطها فرصة تتنفس ، وتستريح بين الشَّولات .
إبتسمت ، وبدأت أكتب الكلمات بلون أشبه بِحُمرة الخجل ! .
أتَذَكَّر يوم ذهبت لزيارته ، وكان فى تللك اللحظة يقف على باب المصعد يتأهب للنزول ، فأمسك بيدى ليعود ويستقبلنى فى مكتبه ، فتشَبَّثت بالأرض فى تَمَنُّع مَشُوب بالإحترام الكبير ، فعاد وأصَرَّ أن يَصحبنى معه إلى طبيب الأسنان الدكتور كمال الإبراشى ، وذهبت معه ..
مازالت نبرات صوتك يا أستاذ تتردد أصدءًا فى أعماقى حين قُلت لى عندما وُلِدَت " ساره " إبنتى :
" وأنا أيضًا صَار عندى بنت " ..
ليست هذه مجرَّد كلمات وإنما " مادة حياة " تمشى فى شرايينى لتتجدد بها دورة الحياة ، والله ما غِبت عن خاطرى ولا ناظرى لحظة يا أستاذ ولا استطاعت الأيام أن تمشى بالنسيان على ذاكرتى ، رغم أيام مَضَت ، وأيام باعدت عن أيام ، ورجال ذهبوا ، ودنيا غير الدنيا ..
وعندما أمر من أمام البيت فإن قلبى ينقبض لمجرَّد تفكيرى أنك لست هنا وأننى لن أعثر ثانية عليك ، وإذا نظرت إلى الطابق الرابع من المبنى أختنق وأنا أقول لنفسى :
ها هنا مكان اللقاء ، ها هنا كل شىء فى مكانه ، لكن لم يكن هو هناك ، وعندما أغادر المكان أشعر كأننى أنفصل عنك من جديد ..
أين كتاباتك ؟
كان هذا هو السؤال الأول الذى عَادةً ما يبدأ به إستقبالى ..
وكنت أبتسم إبتسامة من خذل نفسه وأنا أقدم له بعض ما كتبت من كلمات فإذا هو بعد أن يَمرّ عليها بعينيه بَرقًا يضعها على مكتبه ويقول :
" هايل " ..
قالها بلهجة سأبقى أرتعش كلما تذكّرتها ، تلك هى الكلمة التى كانت تُنْسِينِى كل شىء إلا أن أرتفع إلى مستواها ، وكان رأيه فوق ما تمنيت وأكثر مما طمعت فيه ..
" هَايل " هى الكلمة التى حُرِمت منها مَرتين :
المرَّة الأولى بعد غياب الأستاذ فى مثل هذا اليوم من شهر فبراير الحزين ..
والمرَّةالثانية بعد غياب صديقى وأستاذى المُفكر الموسوعى سيد يسين الذى شَرُفت بأن يكتب المقدمات النقدية لكتبى ، الذى كان أول ما يستقبلنى به هو هذا السؤال :
أين كُتبك ؟
دَعك من كتابة المقالات يا دكتور إن وهج الكتب هو الذى سيبقى أكثر أثرًا .. أنت مُقَصّر فى حق قلمك ، سَلنى أنا الذى يعرف ! .
أتلفت حولى الآن فلا أرى من هذا النموذج الرفيع من الأساتذة العمالقة إلا ما لا أرى ..
لقد تتلمذت على الرُّقِى فى سنوات التوثُّب واليقظة المبكرة ، ، وتعلمت أن أسير إلى جانب أولئك الذين عاشوا لشىء أكبر من أنفسهم ، وكان لخطواتهم أثار لا تنطبع إلا على سطح الضوء ، كلما دنونا منهم تبيَّن لنا عِظَم ومهابة هؤلاء ..
عرفت كيف شاد الأستاذ العقاد مجده الأدبى بأحجار من الجرانيت ، وعِشت معه على الورق ورأيت هذا البناء العظيم وهو يضع حجر فوق حجر، وكنت أسمع صوته فى أذنى بصوت الشعر – إحدى عشر ديوانا من الشعر - والنقد ، والفلسفة ، والهندسة ، والطب ، والديانات ، عرفته كاتبًا " كونيّا " حتى وقعت فى هواه ، وعرفت الدكتور طه حسين شُعَاعًا لم تستطع أن تُطفِؤه ظلمات ، فرد إحتوى بين ضلوعه طموح أمة ، ومن ظلامها قادها إلى النور ، ورأيته يتنقل بين صفحات الكتب وهو ينسِج مجدَه الأدبى بخيوط من حرير ، هذا وسيظل صوت الدكتور طه حسين هو أحب الأصوات إلى نفسى ، بل وأعظم من نطق اللغة العربية قاطبة ، وهو يمثل بوصلة الأدبى العربى ، وتأثرت بالدكتورة نعمات أحمد فؤاد وإلتقينا معًا فى جامعة العقاد نتلقى معًا أبجدية الشموخ والكبرياء والترفّع والعفَاف ، كانت هذه المصرية الأصيلة التى تَجذَّر حُبها عميقًا فى الأرض ، تَودُّ أن يوزَّع رُفَاتها على ماء النهر ، وعلى تلك الأشياء التى لا تتوقف جراحها عن النزيف على أرض مصر ، وغير هؤلاء كُثر أضاءوا عقلى وكانوا دليلى إلى فكرة التقدم .
كلما غاب أحد أساتذتى يزداد إحساسى بالوحدة ، وأنى بت أعيش وحيدًا خارج المعنَى ، كثيرًا ما كنت أقول ذلك لنفسى ، وأكاد أحس هذه الكلمات تلهب حَلقى ..
الجنازة :
فى هذه اللحظة داهم ذاكرتى مشهد الرحيل حين كان النعش يعوم فى الدموع على طول المسافة المُؤدِية من مسجد الإمام الحُسين إلى " دار العودة " حيث يقيم الأستاذ وراء حدود الأبد ، كنت أسير فى جنازته وقد إرتكبت آثام الحُزن إلا أهونها وهو الدموع ، أبكى بكاءًا ظاهرًا ولا أثر للدموع فى عيون أحد ، فنحن نشيّع حَيًّا مليئًا بالحياة ، حَيًّا ترك فى نفس ملايين القرَّاء التى لم يُقَدَّر لها الحضُور شيئًا حيًّا مُتَحَرّكًا ، ثم جَفَّ الدَّمع وبَقى الحنين . فى المدافن كان الزوال يبسط نفوذه على المكان ، وكان الموت هو البطل ، كان فوق الإحتمال أن أنقل مَشهد الزَّوال وهو يَعبر نحو الغياب . فى هذا المكان الموت إشارة تعجب للحياة .
المدفن :
جئت إلى هنا فى مَحَبَّته وليس تذكارًا له لأن التذكّر يرتبط بإستعادة غياب ، وأما المحبَّة فحضور مضىء وكذلك الأستاذ .
وأمام المقبرة وقفت وقفة المتَجَمّد كأنى بيت مكسُور فى قصِيدة رَفض ، أتنفس هواءًا مكتومًا ، مخزُونًا ، وعَصِيًّا ، كنت أتخيله مَسجِىّ بين طيات الثرى جسدًا هامِدًا ورُفاتًا لا يؤنس وحدتها سوى حجر وسكون وتراب ، كنت أحاول أن أقنع نفسى بأنه فقط مُستسلم لنوم عَمِيق ، وبينما تَنَدَّت بالدمعِ عينى كنت أقول لنفسى :
هل الأستاذ يسمع صوتى ؟ هل صوتى يصل إلى عالمه ؟ ثم أفيق من لحظة غياب عابرة على أنى كنت أهذى ، كان الحُزُن قد أخذ منى كل مأخذ .
كنت أقف أمام المدفن مكسور الوجدان أتنفس حزنًا ، رُحتُ أتحسس بأصابعى حروف أسمه المنقوش على قطعة رخام صماء وصورته بخيالى وهو فى مرقده حيث انسحبت كل الأصوات والأضواء ، فى هذه الأثناء لَمَحت فى رُكن قَصِىّ شُجَيّرة وقف على أحد أغصانها عُصفُور خَائِف يُحاصِره الغَيْم ، ولمَّا إشتدَّ به الظَّمأ إنتقل إلى سَقف المدفن ، وأخذ يُغَرّد لكنه لم يجد ما يبلل فيه منقاره غير ماء من بحرهؤلاء الأحباب ..
وبينما كنت أضع باقة ورود فوق القبر لمحت بجوار الحائط وردة نَفَدَ عِطرُها تُهيِّىء نفسها للموت ، وكان بجوارها وردة أخرى أسقَمها الجَفاف وقد استسلمت لنُوم عَميق فى قلب التُّراب ، أنا أعرف هذه الوردة من لونها ورائحة عطرها ، إنها فى زيارتى السابقة كانت تنام فى أحضان الشوك ، وها هى اليوم تنام وحيدة فى أحضان التراب ! .
فى هذه الأثناء بدأت فى قِرَاءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بصوت باكِ غَلبت عليه الدموع ، فى حين ظلَّت نظرات " رمضان " حارس المدفن عالقة بى لا تتحول عنى ، حاولت إخفاء أحزانى لكن الحزن كان أصدق من محاولتى وكان كاشفًا ..
وقبل أن أنصرف وسط القبور فى سكونها الأبدى مُتَجِهًا نحو الشارع ، سمعت صوت " رمضان " حارس المدفن يقول :
" كِفاية يا دكتور " ..
قُلت :
" مَفِيش حاجة يا عم " رمضان" وأمسكت دُمُوعًا تَحَيَّرت فى عينىَّ ، وشِئتُ أن أعتذر ولكن ما وجدت الكلمة التى تليق بتلك الحُرقَة التى تسرَّبت من صَدرى ، فَغَيَّرت مَجرى الحديث ..
ثم وَمَضَ فى خواطرى فهمًا ومعنى أن غَدًا كلُّ منا سيذهب وحده ، وأننا سنوجد دون تفسير نقدّمه ، تَذكّرت يومًا تذُوب فيه صيحاتنا فى التراب ، ورجَوت صَدرى أن يتحمل أحزانًا تتراكم فوق أحزان ، ثم أتجهت الى خارج المدفن هربا من هذا المكان المليىء بعطر عُشَّاق ماتوا ، وأندفعت من حيث لا أدرى ، إلى حيث لا أريد ، وفى طريق العَودة مَرَّ بخاطرى أن هناك بين الموتى لوصوصًا ، ومنافقين ، ومجرمين ، وخبثاء ، ومحتالين ، وعظماء ، ومؤمنين ، وكرماء ، وعصاميين ، كل هذه الطبائع تختلط بالتراب ، تتحلل وتذوب وتندثر وتتلاشى ، ولا يبقى إلا ما قَدَمَت ، وذكرى هى التى تظل على قيد الحياة ! .
ولما عدت إلى بيتى رُحتُ أنظر إلى حذائى المعَفَّر وضَنَنّت أن أنفّض عنه غبَارًا أصبح أحبائى من جُزئياته ، تلك هى اللحظة التى نهارى فيها إنكسر فى منتصف النهار ، ووجدت الليل يستقبلنى لا بِسًا ثيابه القديمة ، لكنه كان كريما معى حين أشفق وساعدنى على النوم " هُنَا " وظل هو ساهرًا يحرس الأبَد " هناك " ، بينما كانت النجوم قد بَدَأت فى عِراكِها مع الكون ، بعضها يشكُو التَعَب ، وبعضها الآخر راح يَتَعَكَز على الفَلكِ ..
بعدها ..
لم يَعُد الغِناء فى حاجة إلى " صوت " ..
ولم يَعُد الشّعر فى حاجة إلى " لُغة " ..
ولم يَعُد الرَّسم فى حاجة إلى " اللَّون " ..
ثم رَجَوت صدرى أن يتحمل أحزانًا تتراكم فوق أحزان ..
وإنصرفت أقول لنفسى :
حقًا ..
الناس يتساوون داخل الأرحام وفى القبور ..
والحياة الحقيقية نائمة تحت التراب ..
غير أن هناك من فى غيابهم أقل موتًا مِنَّا وأكثر مِنَّا حَياة ..
فُرَاق الأحباب مُرَوّع ، ولا نملك إلا أن نُرَوّضَ أنفسنا على الفراق ..
وطلبت راجيًا لو أن السماء تسمح بساعات زيارة ..
للمنتهى أشكال لا تنتهى ..
صورة :
مازلت أحتفظ بالإحساس الذى يسكن الصورة وأنا بجواره ، مازلت أحتفظ بعطر ملابسه لحظة هذا اللقاء الذى طاف بى وزوجتى العظيمة شَاريحًا كل ركن من أركان " المزرعة " وكيف تحولت إلى مزارًا تاريخيًا يقصده الزعماء والملوك والفلاسفة وقادة الفكر والفن الذين تركوا بعضًا منهم فى أروقتها كافة ، حيث جلسوا ، وتكلموا ، وتسامروا ، وتعانقوا ، وإختلفوا أيضًا ، لكن ظلت " مَزرَعَة بِرقَاش " هى نقطة الوصول ، ومَرسَى الإلتقاء ، والإتفاق ، والإختلاف أيضًا ..
لحظات لا تُمحى ..
والحمد لله ..
فقد إعتَدّتُ دائِمًا أن تكون كريمًا معى وتُقَدّر ..
حَقًا ..
ليس أدعى إلى الأسى من يوم تفقد فيه أستاذا صَديقًا تُحِبه ..
فى مثل هذا اليوم منذ أربعة سنوات غاب عن الدنيا أستاذى وصديقى الأستاذ " محمد حسنين هيكل " ، رجل تجاوز جميع الألقاب التى تسبق الأسماء عادة ، هو فى سِجِلات التاريخ والمعرفة الرصينة أحد أعظم أساتذة الصحافة الكونية ، أو كما كان يقول الأوائلُ :
" فى كل ألف سنة رجل لا نظير له " عبارة أستحضرها فى ذهنى تكريمًا ، وتلمع برقُا فى خواطرى إعلاءًا لمن كان وجوده فى الحياة نَصر للحياة . بعد كل لقاء أعود إلى بيتى إنسان غير الذى عَرِفته ..
أتذكّر لحظة الفراق حين كان القمر حَزِينًا شَاحِبًا يشكو ظلمة الليل إلى النُّجوم من حوله ، فيما كانت النُجومّ ساهرةُ تحرس صَمت الفضاء الذى أخذ يبعث لنا بنداء الحقيقة نسمعه يتردد رجع صدى فى الأفق ..
أعرف أنه لا يوجد إنسان لم يحزن فى حياته ، لكن من منكم رأى الحزن وهو يُمطِر ..
كان أعظم ما أحبه وأحترمه فى هذا الأستاذ أنه لم ينس نفسه برغم ما تفتح أمامه من ألأبواب ، وأنه كان يُمَثّل بمفرده عصرًا رأيته رؤى العين ولم أقرأ عنه فقط ، أى أننى استعيد الناس والأماكن وليست الصفحات والكلمات فقط . كنت أزهو أنى موجودُ إلى جوار " لَمعَة نِجم " فى مَجَرَّة فضَائية يَصعُب رَصد حجمها ، ويَصعب حصر تأثيرها ، وأنى كنت مَحظُوظًا أنى أحيَا عصره وأن العصر عصره ، تكرَّمت المقادير وكنت تلميذًا مُقَرَّبًا منه ، ربما تلمس عُمق صِلة بين تلميذ وأستاذ أكبرهما يرى " الوَعد " فى الأصغَرِ ، والأصغر يرى " المثل " فى الأكبر ، وكثيرًا ما كنت بِصُحبَته وهو يسير بِمُحَاذَة السَحاب مُحَلِقًا بأجنحة جاوزت به الأفق المَرئِى وبعده أيضًا ، كنت أسمع وأرى مأخوذًا بِدِهشة الإعجاب برجل إختارأن يكون نفسه وأستاذًا كان له أكبر الأثر فى حياتى باحِثًا قَلما تتاح له المراقبة عن كَثَب ، ودَارِسًا ، ومُحَققًا ، ومُدقِقًا ..
كنت أقرأ المقالات كأنى أكتبها تماما ، وهى مازالت تحتفظ بعلامات قلمى الرصاص تحليلا لعناصرها ، حتى ليُخَيَّل إلىَّ أنى أكتبها ، وأن يدى تعزِفُ إلى جوار يَدِه على نفس الأوتار ، مع أن الكتابة عَزفُ مُنفَرد على أوتار اللغة . كانت كتاباته تبعث برسائل وإشارات ضوئية مُوجزَة إلى أقدَم المَمَرَات للخروج من قتام الليل إلى شروق النهار ..
كان الأستاذ " هيكل " لى ولجيلى جامعة كبرى تعلم فيها كُثُرُ من رجال السياسة والفكر والصحافة دَرسهم الأهم فى عِلم الصراع ..
كان أول درس تعلمته أن أكبر قدر من النجاح يرتبط بأقل قدر من الكلام ، وكلما تكلمنا أكثر كشفنا من مواقعنا واقعة أوسع ، وكلما كشفنا المزيد من مواقعنا ضاقت أمامنا مساحة الحركة وحرية التصرف ، وأن ما أُسَجّله وأدوّنه فى مُفَكِرتى وأوراقى أن يكون وراء كل كلمة سَنَد ، وكل حِكايَة وثِيقَة ، وكل خَبر مَصدرًا .. تعلمت أن القراءة عمل من أعمال " العبادة " ، وأن الكتابة عمل من أعمال " السيادة " وهى تدريب على الإبداع ، وأن سِعة الصَّدر عند بعض الناس مَوهِبة ، وأن الكبار لا تنزلق أقلامهم فى مستنقع الضغائن ، تَعَلَّمت فلسفة " النسيان العَادِل " ، وأن عليك أن تتأكد من جناحىَّ قبل الطير ، ولا تتحدث عن الفضاء والأجنحة مقصوصة ، وأن القلق عنصرا خلاقا ويبعث على التفكير والخروج من المأذق ، وأن الحوار هو مُحرك الثقافة ومدار الحضارة ، وليس كل جديد صحيحًا ، وليس كل صحيح جديدًا ، وكان أكثر ما تعلمت هو أن أكون " نفسِى " .
عرفت الأستاذ " هيكل " طائِرًا مُحَلقًا يتجاهل كل الحُدُود ، صَوته فى أجنحته ، الحُريَّة عنده ليست حُرَّةُ ، فهى مُقَيَّدة بأفق الشَّخص الذى يُمَارسها ، وأن كل مُثَقَّف مُكَلَّف بتوسيع دائرة الحرية وعليه أن يختار ميادينه وحركته عليها بدِقَّة ، لأن أى تراجُعِ يفرض عليه معناه أن خطوط الحدود " ضَاقَت " وأن بعض المكاسب على الأرض " ضَاعَت " . عَرفته شعاعًا قادرًا هو على النفاذ إلى جوهر السَّوَاد ، عَرفت الشموخ ، والترفّع الإنسانى البديع ، وتلك الكبرياء العالية ، وعرفت المُفَكّر الذى خُلق ليقرأ ويكتب ويضِىء ، وكلها قِيَمًا عَالية ظلت دومًا فى حافظته المهنية ..
إختَلِف معه فى الرأى والرؤى كيفما شئت ، وأعترف أن هناك مناطق اختلاف بينى وبينه حول بعض القضايا ، بل وكانت بعض مناطق الإختلاف تتسع وقد لا تضيق ، ذلك أنى لا أقنع إلا بما هو مُقنِغ ، ومازلت إحتفظت بثبات موقفى عند نقطة الإعتقاد لا أتزحزح عنها حتى الآن ، لكنك لا تملك إلا أن تقف مأخوذا أمام الصفاء العقلى ، والرواء الفنى ، والشموخ الهندسى فى مقالاته ، وجلال اللغة ، وأسلوبه الساحر .. ولمن يريد أن يدقق ، فإن الأستاذ هيكل إستطاع أن يحقق فى كتاباته نوعًا من الإبتكار ، ذلك حين قام بعقد قَرانًا لُغَوِيًا بين المصطلح السياسى والتعبير الأدبى ، زيجة أدبية وفنية لم تعرفها الصحافة المصرية والعربية ، ولم تظهر إلا مع مقاله الأشهر " بصراحة " الذى ينهض على التحليل العنقودى للوقائع والأحداث ..
إختار الأستاذ " محمد حسنين هيكل " الصحافة بوصفها عِشقًا ، وظلّت دَومًا هى غَرامه وهواه ، وصارت هى كل ما يراه ، إختارها بوصفها فى لحظة فارقة المعنى على طريق تشعبت مسالكة ، وتقاطعت خطوطه ، وزادت منحنياته ومهاويه لتكون هى حياته التى يعيش فيها ، ورسالته التى بُعِثَ من أجلها ، وهى التى أعطاها عُمره ، وهى التى جَرى فى دِمائه عِطرُها ، وهى التى أخلص لها ، وظل وفِيًّا لطقوسها وأعرافها من لحظة الخلق وحتى صمت القبور ، فكان هذا الصعود المدهش على سُلّم المَعنى درجة بعد درجه ، وطابق يرتفع فوق طابق تحته ، بِصَبرِ فاهم وجلد ، حتى وصل الدرجة الأخيرة فى سُلم الضوء . وعلى طول المسافة الممتدة التى قضاها ناسِكا فى مِحراب الصحافة بوصفها " تاريخ تحت الطبع " ظل مُحَاطا بوهجِ خاطف أخَّاذ لا ينطفىء أبدًا ، وهوأينما ذهب أخذ معه هذا الوَهج على نحو باهرِ ومُدهِش ..
أذكر مرّة كان الأستاذ يُملى علىّ موضوعًا مهمًا ، وكان يقرأ الكلمات بسرعة ، وكنت أكتب وراءه العبارات بدون " شَولات " كى ألاحقه فإذا هو يقول لى :
أنت تكتب بدون سَكَتَات أى " شَولات " الكلمات تلهث إعطها فرصة تتنفس ، وتستريح بين الشَّولات .
إبتسمت ، وبدأت أكتب الكلمات بلون أشبه بِحُمرة الخجل ! .
أتَذَكَّر يوم ذهبت لزيارته ، وكان فى تللك اللحظة يقف على باب المصعد يتأهب للنزول ، فأمسك بيدى ليعود ويستقبلنى فى مكتبه ، فتشَبَّثت بالأرض فى تَمَنُّع مَشُوب بالإحترام الكبير ، فعاد وأصَرَّ أن يَصحبنى معه إلى طبيب الأسنان الدكتور كمال الإبراشى ، وذهبت معه ..
مازالت نبرات صوتك يا أستاذ تتردد أصدءًا فى أعماقى حين قُلت لى عندما وُلِدَت " ساره " إبنتى :
" وأنا أيضًا صَار عندى بنت " ..
ليست هذه مجرَّد كلمات وإنما " مادة حياة " تمشى فى شرايينى لتتجدد بها دورة الحياة ، والله ما غِبت عن خاطرى ولا ناظرى لحظة يا أستاذ ولا استطاعت الأيام أن تمشى بالنسيان على ذاكرتى ، رغم أيام مَضَت ، وأيام باعدت عن أيام ، ورجال ذهبوا ، ودنيا غير الدنيا ..
وعندما أمر من أمام البيت فإن قلبى ينقبض لمجرَّد تفكيرى أنك لست هنا وأننى لن أعثر ثانية عليك ، وإذا نظرت إلى الطابق الرابع من المبنى أختنق وأنا أقول لنفسى :
ها هنا مكان اللقاء ، ها هنا كل شىء فى مكانه ، لكن لم يكن هو هناك ، وعندما أغادر المكان أشعر كأننى أنفصل عنك من جديد ..
أين كتاباتك ؟
كان هذا هو السؤال الأول الذى عَادةً ما يبدأ به إستقبالى ..
وكنت أبتسم إبتسامة من خذل نفسه وأنا أقدم له بعض ما كتبت من كلمات فإذا هو بعد أن يَمرّ عليها بعينيه بَرقًا يضعها على مكتبه ويقول :
" هايل " ..
قالها بلهجة سأبقى أرتعش كلما تذكّرتها ، تلك هى الكلمة التى كانت تُنْسِينِى كل شىء إلا أن أرتفع إلى مستواها ، وكان رأيه فوق ما تمنيت وأكثر مما طمعت فيه ..
" هَايل " هى الكلمة التى حُرِمت منها مَرتين :
المرَّة الأولى بعد غياب الأستاذ فى مثل هذا اليوم من شهر فبراير الحزين ..
والمرَّةالثانية بعد غياب صديقى وأستاذى المُفكر الموسوعى سيد يسين الذى شَرُفت بأن يكتب المقدمات النقدية لكتبى ، الذى كان أول ما يستقبلنى به هو هذا السؤال :
أين كُتبك ؟
دَعك من كتابة المقالات يا دكتور إن وهج الكتب هو الذى سيبقى أكثر أثرًا .. أنت مُقَصّر فى حق قلمك ، سَلنى أنا الذى يعرف ! .
أتلفت حولى الآن فلا أرى من هذا النموذج الرفيع من الأساتذة العمالقة إلا ما لا أرى ..
لقد تتلمذت على الرُّقِى فى سنوات التوثُّب واليقظة المبكرة ، ، وتعلمت أن أسير إلى جانب أولئك الذين عاشوا لشىء أكبر من أنفسهم ، وكان لخطواتهم أثار لا تنطبع إلا على سطح الضوء ، كلما دنونا منهم تبيَّن لنا عِظَم ومهابة هؤلاء ..
عرفت كيف شاد الأستاذ العقاد مجده الأدبى بأحجار من الجرانيت ، وعِشت معه على الورق ورأيت هذا البناء العظيم وهو يضع حجر فوق حجر، وكنت أسمع صوته فى أذنى بصوت الشعر – إحدى عشر ديوانا من الشعر - والنقد ، والفلسفة ، والهندسة ، والطب ، والديانات ، عرفته كاتبًا " كونيّا " حتى وقعت فى هواه ، وعرفت الدكتور طه حسين شُعَاعًا لم تستطع أن تُطفِؤه ظلمات ، فرد إحتوى بين ضلوعه طموح أمة ، ومن ظلامها قادها إلى النور ، ورأيته يتنقل بين صفحات الكتب وهو ينسِج مجدَه الأدبى بخيوط من حرير ، هذا وسيظل صوت الدكتور طه حسين هو أحب الأصوات إلى نفسى ، بل وأعظم من نطق اللغة العربية قاطبة ، وهو يمثل بوصلة الأدبى العربى ، وتأثرت بالدكتورة نعمات أحمد فؤاد وإلتقينا معًا فى جامعة العقاد نتلقى معًا أبجدية الشموخ والكبرياء والترفّع والعفَاف ، كانت هذه المصرية الأصيلة التى تَجذَّر حُبها عميقًا فى الأرض ، تَودُّ أن يوزَّع رُفَاتها على ماء النهر ، وعلى تلك الأشياء التى لا تتوقف جراحها عن النزيف على أرض مصر ، وغير هؤلاء كُثر أضاءوا عقلى وكانوا دليلى إلى فكرة التقدم .
كلما غاب أحد أساتذتى يزداد إحساسى بالوحدة ، وأنى بت أعيش وحيدًا خارج المعنَى ، كثيرًا ما كنت أقول ذلك لنفسى ، وأكاد أحس هذه الكلمات تلهب حَلقى ..
الجنازة :
فى هذه اللحظة داهم ذاكرتى مشهد الرحيل حين كان النعش يعوم فى الدموع على طول المسافة المُؤدِية من مسجد الإمام الحُسين إلى " دار العودة " حيث يقيم الأستاذ وراء حدود الأبد ، كنت أسير فى جنازته وقد إرتكبت آثام الحُزن إلا أهونها وهو الدموع ، أبكى بكاءًا ظاهرًا ولا أثر للدموع فى عيون أحد ، فنحن نشيّع حَيًّا مليئًا بالحياة ، حَيًّا ترك فى نفس ملايين القرَّاء التى لم يُقَدَّر لها الحضُور شيئًا حيًّا مُتَحَرّكًا ، ثم جَفَّ الدَّمع وبَقى الحنين . فى المدافن كان الزوال يبسط نفوذه على المكان ، وكان الموت هو البطل ، كان فوق الإحتمال أن أنقل مَشهد الزَّوال وهو يَعبر نحو الغياب . فى هذا المكان الموت إشارة تعجب للحياة .
المدفن :
جئت إلى هنا فى مَحَبَّته وليس تذكارًا له لأن التذكّر يرتبط بإستعادة غياب ، وأما المحبَّة فحضور مضىء وكذلك الأستاذ .
وأمام المقبرة وقفت وقفة المتَجَمّد كأنى بيت مكسُور فى قصِيدة رَفض ، أتنفس هواءًا مكتومًا ، مخزُونًا ، وعَصِيًّا ، كنت أتخيله مَسجِىّ بين طيات الثرى جسدًا هامِدًا ورُفاتًا لا يؤنس وحدتها سوى حجر وسكون وتراب ، كنت أحاول أن أقنع نفسى بأنه فقط مُستسلم لنوم عَمِيق ، وبينما تَنَدَّت بالدمعِ عينى كنت أقول لنفسى :
هل الأستاذ يسمع صوتى ؟ هل صوتى يصل إلى عالمه ؟ ثم أفيق من لحظة غياب عابرة على أنى كنت أهذى ، كان الحُزُن قد أخذ منى كل مأخذ .
كنت أقف أمام المدفن مكسور الوجدان أتنفس حزنًا ، رُحتُ أتحسس بأصابعى حروف أسمه المنقوش على قطعة رخام صماء وصورته بخيالى وهو فى مرقده حيث انسحبت كل الأصوات والأضواء ، فى هذه الأثناء لَمَحت فى رُكن قَصِىّ شُجَيّرة وقف على أحد أغصانها عُصفُور خَائِف يُحاصِره الغَيْم ، ولمَّا إشتدَّ به الظَّمأ إنتقل إلى سَقف المدفن ، وأخذ يُغَرّد لكنه لم يجد ما يبلل فيه منقاره غير ماء من بحرهؤلاء الأحباب ..
وبينما كنت أضع باقة ورود فوق القبر لمحت بجوار الحائط وردة نَفَدَ عِطرُها تُهيِّىء نفسها للموت ، وكان بجوارها وردة أخرى أسقَمها الجَفاف وقد استسلمت لنُوم عَميق فى قلب التُّراب ، أنا أعرف هذه الوردة من لونها ورائحة عطرها ، إنها فى زيارتى السابقة كانت تنام فى أحضان الشوك ، وها هى اليوم تنام وحيدة فى أحضان التراب ! .
فى هذه الأثناء بدأت فى قِرَاءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بصوت باكِ غَلبت عليه الدموع ، فى حين ظلَّت نظرات " رمضان " حارس المدفن عالقة بى لا تتحول عنى ، حاولت إخفاء أحزانى لكن الحزن كان أصدق من محاولتى وكان كاشفًا ..
وقبل أن أنصرف وسط القبور فى سكونها الأبدى مُتَجِهًا نحو الشارع ، سمعت صوت " رمضان " حارس المدفن يقول :
" كِفاية يا دكتور " ..
قُلت :
" مَفِيش حاجة يا عم " رمضان" وأمسكت دُمُوعًا تَحَيَّرت فى عينىَّ ، وشِئتُ أن أعتذر ولكن ما وجدت الكلمة التى تليق بتلك الحُرقَة التى تسرَّبت من صَدرى ، فَغَيَّرت مَجرى الحديث ..
ثم وَمَضَ فى خواطرى فهمًا ومعنى أن غَدًا كلُّ منا سيذهب وحده ، وأننا سنوجد دون تفسير نقدّمه ، تَذكّرت يومًا تذُوب فيه صيحاتنا فى التراب ، ورجَوت صَدرى أن يتحمل أحزانًا تتراكم فوق أحزان ، ثم أتجهت الى خارج المدفن هربا من هذا المكان المليىء بعطر عُشَّاق ماتوا ، وأندفعت من حيث لا أدرى ، إلى حيث لا أريد ، وفى طريق العَودة مَرَّ بخاطرى أن هناك بين الموتى لوصوصًا ، ومنافقين ، ومجرمين ، وخبثاء ، ومحتالين ، وعظماء ، ومؤمنين ، وكرماء ، وعصاميين ، كل هذه الطبائع تختلط بالتراب ، تتحلل وتذوب وتندثر وتتلاشى ، ولا يبقى إلا ما قَدَمَت ، وذكرى هى التى تظل على قيد الحياة ! .
ولما عدت إلى بيتى رُحتُ أنظر إلى حذائى المعَفَّر وضَنَنّت أن أنفّض عنه غبَارًا أصبح أحبائى من جُزئياته ، تلك هى اللحظة التى نهارى فيها إنكسر فى منتصف النهار ، ووجدت الليل يستقبلنى لا بِسًا ثيابه القديمة ، لكنه كان كريما معى حين أشفق وساعدنى على النوم " هُنَا " وظل هو ساهرًا يحرس الأبَد " هناك " ، بينما كانت النجوم قد بَدَأت فى عِراكِها مع الكون ، بعضها يشكُو التَعَب ، وبعضها الآخر راح يَتَعَكَز على الفَلكِ ..
بعدها ..
لم يَعُد الغِناء فى حاجة إلى " صوت " ..
ولم يَعُد الشّعر فى حاجة إلى " لُغة " ..
ولم يَعُد الرَّسم فى حاجة إلى " اللَّون " ..
ثم رَجَوت صدرى أن يتحمل أحزانًا تتراكم فوق أحزان ..
وإنصرفت أقول لنفسى :
حقًا ..
الناس يتساوون داخل الأرحام وفى القبور ..
والحياة الحقيقية نائمة تحت التراب ..
غير أن هناك من فى غيابهم أقل موتًا مِنَّا وأكثر مِنَّا حَياة ..
فُرَاق الأحباب مُرَوّع ، ولا نملك إلا أن نُرَوّضَ أنفسنا على الفراق ..
وطلبت راجيًا لو أن السماء تسمح بساعات زيارة ..
للمنتهى أشكال لا تنتهى ..
صورة :
مازلت أحتفظ بالإحساس الذى يسكن الصورة وأنا بجواره ، مازلت أحتفظ بعطر ملابسه لحظة هذا اللقاء الذى طاف بى وزوجتى العظيمة شَاريحًا كل ركن من أركان " المزرعة " وكيف تحولت إلى مزارًا تاريخيًا يقصده الزعماء والملوك والفلاسفة وقادة الفكر والفن الذين تركوا بعضًا منهم فى أروقتها كافة ، حيث جلسوا ، وتكلموا ، وتسامروا ، وتعانقوا ، وإختلفوا أيضًا ، لكن ظلت " مَزرَعَة بِرقَاش " هى نقطة الوصول ، ومَرسَى الإلتقاء ، والإتفاق ، والإختلاف أيضًا ..
لحظات لا تُمحى ..